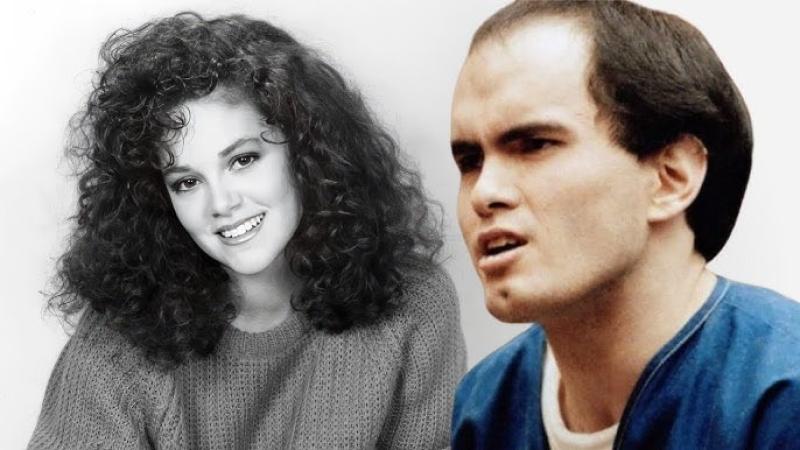أنا طفل وعمري خمسة وثمانون عاماً! (2)

نستكمل اليوم القصة القديمة.. الجديدة.. المتكررة، لطفل الطنطورة العجوز:
أعدت الحجرين لموضعهما بيدين مرتعشتين، ووضعت المقعد مكانه، وتراجعت أجلس القرفصاء مرتجفا عند الحائط المقابل.. وبعد لحظات سمعت صوت طلقة واحدة، ثم سكت الرضيع عن البكاء.. شعرت أن خطوات الرجل تبتعد شيئاً فشيئا
عدت بحذر لأرفع الحجرين، فوجدت ذلك الرجل يتراقص بخفة، ويستقبله الاثنان الآخران وهم يتقاذفون فيما بينهم لعبة على هيئة دمية لطفل صغير، قبل أن يلقي بها أحدهم على قارعة الطريق، ثم غادروا المكان.
دققت النظر إلى الدمية لعلها لعبة من ألعاب أختي سمر، فإذا بخط من الدماء يخرج من ثقب كبير في جبهتها وينسال على الأرض، فاكتشفت أن تلك الدمية التي كانوا يلهون بها هي الرضيع الذي أزعجهم صوت بكائه فأخرسوه للأبد..
انطلقت باكياً إلى غرفتي، أرتمي فوق الفراش لعله كابوس سأصحو منه حتما، أو ستوقظني يد أمي الحانية وهي تهدئ من روعي، وتتساءل عن سر بكائي، وتلك الرجفة والهلاوس، قبل أن تلومني بشدة على أني بللت سروالي..
مر الوقت ثقيلا، ولم أستطع النوم.. افتقد أبي وأمي واخوتي كثيرا، وأترقب لحظات العودة وانفجاري غاضباً في وجه الجميع على ما فعلوه بي، وتركهم لي وحدي كل هذا الوقت.. أتخيل أبي وهو يحمل بيديه لعبة القطار التي طلبتها منه منذ أسبوع، وأمي حاملة للزينة والورود تخبرني بأنها مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادي..
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.. لم أعد أميز الأوقات، لم أعرف هل مرت دقائق أم ساعات .. أم دهور.. أو إن الزمن نفسه قد توقف.. لم أقترب ثانية لثقب الجدار كي أعرف هل حل الليل أم لا.. شعرت بضوء المصباح وقد بدأ يخفت تدريجياً مع اقتراب الشمعة من لحظة الوداع..
وفجأة، بدا لو كان أحدهم يضع مفتاحا بالباب ويديره ببطء.. شعرت بالهلع وسقطت من فوق الفراش كالحجر، ثم زحفت مستقرا تحته، وعيناي تترقب هوية الداخل إلى الدار.. هل يكون أبي أم أمي؟ أم أحد هؤلاء الرجال الذين يقتلون الكبار والصغار وحتى الرضع ولا أعلم لماذا!!
رأيت شخصاً يفتح الباب بهدوء، ويتسلل للداخل على أطراف أصابعه حذرا، متلفتا وراءه، ومن ثم اغلق الباب خلفه، ثم بدأ يهمس بصوت خفيض: وليد .. وليد.. هل أنت هنا؟
ازداد قلقي وخوفي، وشعرت كأنني انكمش وانكمش تحت الفراش حتى قاربت على الاختفاء.. ثم دخل الزائر الغامض إلى غرفتي.. وللحظة، انعكس ضوء المصباح على وجهه.. إنه خالي ابو الفضل.. عرفته رغم الجرح الغائر الذي ترك علامة على وجهه، وحالة ملابسه الرثة التي اختلطت بها الدماء مع الرمال والطين..
صرخت صرخة عالية أفرغت بها كل معاناتي وآلام نفسي وروحي، وانفجرت باكيا مرتعشا: خالي أبو الفضل
أسرع نحوي واضعاً كفه فوق شفتاي ليجبرني على الصمت، ثم احتضنني بقوة ليهدئ من روعي، ثم أشار إلىّ بسبابته على فمه .. فهززت رأسي علامة على التفهم والطاعة.. رفع يده من على فمي، وقال لي بلهجة، حملت خليطا من الحنان والشجن والحزن والشفقة مجتمعين: هل أكلت؟
نظرت إلى وجهه الشاحب، وعيناه الدامعتين وقلت له وكأنني لم أسمع السؤال: أين أبي وأمي وإخوتي؟
لم يكرر السؤال ولم يجبني على سؤالي، وإنما نهض واقفاً يلملم ما وجده من ماء وطعام، ووضعه بحقيبة علقها على كتفه، ثم نظر إلى وقال: هيا بنا ، لابد أن نرحل في الحال..
_ خالي!! ماذا حل بأهلي؟ ماذا حل بقريتنا؟
_ هيا يا وليد، لا وقت لدينا، سأخبرك بكل شيء ولكن لابد أن نرحل الآن..
استجبت له مستسلما، وتحركنا نحو باب الدار، ثم فتحه بحذر، وخرجت لأجد بعضا من أهل القرية ينتظروننا بالخارج، ما بين رجال قليلين، وعدد من النسوة يحملن أغراضهن فوق رؤوسهن، وأطفالهن فوق أكتافهن.. وجوه شاحبة وعيون زائغة، ونظرات لأطفال تحكي ملامحهم ما مروا به من رعب ومعاناة..
سرت بجواره متشبسا بيده، اتحرك معهم بخطواتهم الثقيلة الحذرة.. يلمحني خالي وانا انظر ملتاعا إلى جثة متفحمة، أو جسد يبدو أنه كان لطفل لا أعرفه حيث لا وجود لرأسه، فيضع يده على رأسي مديرا لها، ويأمرني بعينه فقط أن أكمل المسير ناظراً إلى الأمام.. كنت اخدعه احيانا لأبدو مطيعا، ولكني كنت حريصا على المشي حذرا، لعلني ادهس دون قصد كفا لولد صغير، أو التعثر فوق الركام، فأدوس بقدمي على ضفيرة خرجت لتتدلى، تاركة باقي رأس وجسد الصغيرة خلف حطام بيت أصبح أثرا بعد عين.. وللحديث بقية..